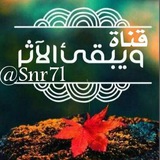
Subscribe to a channel


 963
963
Telegram-канал snr7l - بِِصٌمَةّ خَيِّر
 963
963
●تلاوات قرآنية منوعة ●قصص وحكم ومواعظ ●خواطر وهمسات راقية ●مسابقات إسلامية * وكل ما هو قيم ومفيد * ✔️ تاريخ تأسيس القناة: 2017/3/12 #قبل المغادرة،ارسل سبب مغادرتك هنا ،ڪي نصحح اخطاءنا،وشڪرا 🌸↓ للـتـواصـل ↓🌸 @Snr7lbot ↓↓نـَسـعـَدُ بـِگـم↓↓